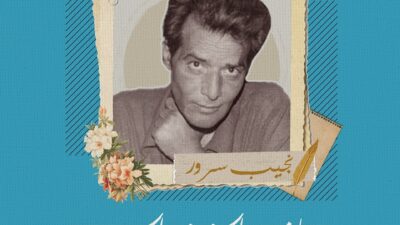في زمنٍ كان يُنظر فيه إلى المسرح كوسيلةٍ للترفيه والتسلية فقط، وتُقدَّم فيه عروضٌ خفيفة غالبًا مرتجلة، جاء ليكسر هذا الإطار السائد، ويحوِّل الخشبة إلى منبر للفكر والنقد والتأمل. لم تكن مسرحياته مجرد عروضٍ مرحة أو قصصٍ تقليديَّة، بل كانت نصوصًا أدبيَّة عميقة تحمل رؤى فلسفيَّة وتساؤلات إنسانيَّة كبرى. بأسلوبه المميز الذي جمع بين البساطة والعمق، أعاد تعريف وظيفة المسرح؛ فجعله وسيلةً لتحريك العقول لا مجرد وسيلةٍ لإرضاء الحواس.
في بيئةٍ شبه أرستقراطيَّة وُلد “توفيق الحكيم”، لأبٍ مصري من أصل ريفي يعمل بالقضاء، وأمٍ من أصل تركي تسعى لدمج زوجها في حياة المدن والطبقة الراقية؛ لكنها لم تنجح في ذلك. ساعدها طموح زوجها في تحقيق مكانةٍ مميزة ضمن الطبقة الحاكمة من المثقفين؛ مما جعل توفيق ينشأ في بيئةٍ تمزج بين ماضٍ ريفي وحاضرٍ مدني؛ فأصبح يُعاني صراعًا داخليًا بين ميوله الفطريَّة كفلاح، وبين متطلبات الحياة الراقية التي فرضتها والدته عليه.
أثَّر هذا الصراع في تشكيل شخصيته.. فمنذ صغره كان توفيق شديد التأمل، حساسًا، لا يهتم كثيرًا بألعاب الطفولة أو التسلية كأقرانه، بل كان دائم الانشغال بالأفكار، وكأن ذهنه يعمل في عالمٍ أخر مليء بالتأمل والتساؤلات؛ لتكون تلك البذرة التي نَمَت وأضفت على كتابته نزعة تخيليَّة، وبشَّرت بظهور أديبٍ ومفكر يُثري تاريخ بلده الثقافي.
“توفيق الحكيم: بين القانون والأدب”
فقد الاستقرار في حياته، فبعدما أنهى مرحلته الابتدائيَّة بمدرسة دمنهور، انتقل إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة “محمد علي التوجيهيَّة”. ترك بصمته في ثورة (1919) من خلال مشاركته القويَّة بها؛ ليكتب بعدها مسرحيته الأولى “الضيف الثقيل” كإشارةٍ للاحتلال البريطاني. وما إن أنهى دراسته بكليَّة “الحقوق” وتخرَّج منها عام (1925)، سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا في القانون، وكان قد حان لهذا العقل المُفكر أن يرسو في الميناء ويُفرغ بضاعته الفكريَّة والإبداعيَّة؛ لذلك اتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي، ووجد على: المسارح الفرنسيَّة، الأوبرا وقاعات السينما ما يبحث عنه.
“شكسبير المسرح العربي”
عاش الحكيم في فرنسا نحو ثلاثة أعوام، يتأمل أدبها ويتعلم من مسارحها، ولم يكتفِ بالمشاهدة بل تحرَّك قلمه ثائرًا لتخرج مسرحيته “أمام شباك التذاكر”، التي حرر فيها خياله المحبوس.
ومنها بدأت بصمته على المسرح تتكون شيئًا فشيء، بأسلوبٍ يغلب عليه العمق الفكري والفلسفي، وبراعته في استخدام الرمز للتعبير عن أفكاره، فجاءت مسرحيته المشهورة “أهل الكهف” عام (1933) كحدثٍ مهم، وبداية لنشوء تيار مسرحي عُرف بـ”المسرح الذهني”، الذي يكشف للقارئ عالمًا من الدلائل والرموز التي يُمكن إسقاطها على الواقع بسهولةٍ ويسر؛ وهو ما يُفسر صعوبة تجسيد مسرحياته وتمثيلها على خشبة المسرح، إذ يقول: “إني اليوم أُقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكارًا تتحرك في المطلق من المعاني مُرتديةً أثواب الرموز، لهذا اتسعت الهُوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة”.
“لولا الحكيم ما أدركتُ معنى الفن.. ولا ماهيته وجماله” – نجيب محفوظ.
لم يكن نصيبنا منه مقتصرًا على الأدب المسرحي فقط، بل أثرى المكتبة العربيَّة بالعديد من الروايات والقصص والمقالات، بداية من “عودة الروح”.. فلم تكن مجرد رواية، بل كانت مصدر إلهامٍ لجيل بأكمله! إذ جسَّد فيها القيم الوطنيَّة وأعاد إحياء مجد مصر القديم، وكذلك برز نقده الاجتماعي والسياسي في “يوميات نائب في الأرياف” التي صوَّرت الفساد الإداري والبيروقراطيَّة، و”الرباط المقدس” التي تناولت مشكلات الزواج والعلاقات الإنسانيَّة. كما اعتمد بشكلٍ أساسي على الحوار في كتاباته ونجد ذلك في مسرحيات: السلطان الحائر، شهرزاد، بجماليون، بالإضافة إلى الملك أوديب.
أعطى لبلده أدبًا ثريًا وإتقانًا في مناصبه التي تولاها، فعمل: وكيلًا للنائب العام في المحاكم المختلطة بالإسكندرية ثم في المحاكم الأهليَّة، وفي سنة (1934) انتقل من السلك القضائي ليعمل مديرًا للتحقيقات بوزارة المعارف، ثم مديرًا لمصلحة الإرشاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعيَّة، ثم عمل بجريدة “أخبار اليوم” التي نشر بها سلسلة من مسرحياته، وعُيِّن مديرًا لدار الكتب الوطنيَّة سنة (1951)، وبعدها قصد باريس لتمثيل بلاده بمنظمة اليونيسكو، ثم عاد إلى القاهرة (1960) ليستأنف وظيفته بالمجلس الأعلى للفنون. وقد منحه الرئيس جمال عبد الناصر “قلادة الجمهوريَّة” تكريمًا له، كما مُنح جائزة الدولة التقديريَّة في الآداب عام (1961).
لم يقتصر تأثيره على الأدب فقط، بل امتدَّ ليشمل الحركة الاجتماعيَّة، حيث كان يُؤمن بضرورة القضاء على الظلم والفساد لتحقيق التقدم؛ لذلك أولى الاهتمام بالمسرح والدراما وأشعل فيهما الروح القوميَّة. وبعد مسيرةٍ حافلة بالإبداع والإنجازات، وحياةٍ قضاها للأدب والفكر، غادر عالمنا في (26) يوليو (1987)، تاركًا إرثًا ثقافيًا وفكريًا غنيًا لا يزال يُؤثر في الأجيال حتى اليوم. قال عنه محمود عبد الشكور: “شَغَل الحكيم الدنيا منذ ظهوره في الحياة الأدبيَّة حتى وفاته، كان مؤسسة مستقلة، وظلَّت أخباره في المستشفى الذي نُقل إليه مثار متابعة شبه يوميَّة”.